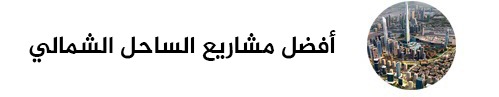كمال زاخر
الثلاثاء 9 سبتمبر 2025
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كما توقعت جاءت تعليقات اصدقاء عديدين على مقالي الذي تناولت فيه أجواء ونص مقال الأب متى المسكين "تصحيح"، الذي نشره فى مجلة مرقس الصادر عن ديره، عدد سبتمبر 1981، وبطبيعة الحال توزعت التعليقات بين متحفظ ومؤيد ورافض ومعارض، لكنها كانت راقية وموضوعية لم تقع في شراك الشخصنة، الأمر الذي يؤكد يقيني بأننا نملك ادارة حوار جيد وبنَّاء، ربما يبلور رؤى للخروج من العديد من أزماتنا بحلول قابلة للتطبيق.
وبالضرورة اتفهم ما ذهبتِ إليه التعليقات، والتي اعادت إلى الذاكرة وقائع وأحداث تلك الأيام الغابرة، الصادمة والمؤلمة، التي شهدنا فيها موجات ممنهجة تستهدف الأقباط عبر سلسلة لا تتوقف من جرائم الاعتداء على الكنائس وتدميرها على من فيها، واستهداف حياة ووجود الأقباط، والتي ظلت قائمة حتى أحداث كنيسة القديسين التي كانت واحدة من العوامل التي فجرت دوائر الغضب في الشارع المصري، يناير ٢٠١١.
والأمر في تقديري يتجاوز اختلاف بين رجلين، البابا والراهب، لهما ثقلهما، بقدر ما هو كاشف عن اختلاط المفاهيم والأمور، وقد نشأ بفعل السياسات التي تبنتها الدولة تجاه قضايا وحقوق الأقباط، والتي شهدت احدى مآسيها في حكم الرئيس الأسبق السادات، وان كانت بذورها نثرت في ارض مصر قبله بعقود، ربما في التاريخ المنظور، مع تأسيس جماعة الإخوان المسلمين ١٩٢٨ بشعارها ومبادئها المعلنة. وما تولد عنها من تنظيمات وجماعات راديكالية عنفية متطرفة.
الأزمة تفاقمت مع أمرين:
* الأول هو اختزال الدولة للأقباط في الكنيسة واختزال الكنيسة في الإكليروس والذين تم اختزالهم في شخص البابا، بحسب تحليل الدكتور ميلاد حنا.
* الثاني هو تفريغ المجلس الملي من جدواه وصلاحياته، بعد قرارات الدولة، 1955 ـ 1962، فيما يتعلق بضم المدارس والمستشفيات لها، و تقليص الأوقاف خاصة الزراعية بقانون الاصلاح الزراعي، وقبل هذا الغاء المحاكم الشرعية والملية واحالتها للقضاء المدني، وهي كلها أمور كانت تحت إدارة المجلس، ليصبح مجلساً بلا صلاحيات، سوي مراقبة إدارة اموال الكنيسة، وحتى هذه تقلصت عملياً برسامة اعضاء المجلس شمامسة.
ففقدنا الصوت القبطي المدني الذي يتصدي للشأن العام والسياسي، ويجنب الكنيسة التورط في الشأن السياسي، ويرفع الحرج عن أطراف المعادلة السياسية، إذ ينطلق دورهم من أرضية المواطنة بغير خلفيات دينية مذهبية.
كان من الطبيعي والأمر كذلك ان يصير البابا رجل دين ورجل سياسة، وصار الناطق سياسيا باسم الأقباط.
هنا تبرز المشكلة، هل يأتي رد فعل البابا بصفته الدينية أم السياسية؟.
وكان من الطبيعي في هذه الأجواء أن تأتي رؤية الشارع القبطي ـ المُستَبعَد سياسياً ـ مرحبة بقرارات الاحتجاج بعدم صلاة قداس عيد القيامة في الكاتدرائية بالقاهرة ومن ثم عدم استقبال المهنئين الرسميين، واعتكاف البابا بديره بصحراء وادي النطرون، اضافة الي عوامل شخصية عند الرئيس والبابا.
لكن هذا لا يمنع انها واحدة من تجليات خلط ما هو لله وما هو لقيصر، كنسياً.
ونجد انفسنا بين نارين؛ السياسة والدين.
إنحاز البابا للسياسة.
فيما انحاز الراهب للدين.
وإن كان هناك من يرى ـ كما أبانت بعض التعليقات ـ أن العكس هو الصحيح؛ إذ يرون أن موقف البابا جاء منطلقاً من كونه راعياً يزود عن رعيته بحكم مسئولياته الرعوية، خاصة عندما يكون الخطر قادم من السلطة السياسية مدعومة بتوجه اختطاف الشارع إلى المربع الديني الأحادي الرافض لقبول آخر.
بينما يرون أن موقف الراهب سياسي بامتياز إذ طوع النص الديني في ترسيخ مفهوم العزلة والنأي عن مواجهة الأحداث التي تنال من حياة وسلامة بل ووجود الأقباط.!!
كان لكلاهما مبرراته، وكانت السياسة حاضرة بقوة في الأحداث. بصورة أو بأخرى.
اظن ان غياب آليات الدولة المدنية، المؤسسات النيابية ـ الفاعلة ـ تحديداً، والتي تعد واحدة من كوابح انفراد السلطة التنفيذية بالقرار، وانخفاض سقف الحوار ، وانتقاله من الديالوج إلى المونولوج، وتدهور انساق التعددية، لحساب الحزب الواحد والرأى الأوحد، وشيوع مناخ الخوف من البوح، واختزال المؤسسات - الدولة والكنيسة - في شخص، هي الأزمة الحقيقية إذ تضافرت كلها لتخلق المناخ الطائفي الخانق، وتنقل المؤسسة الدينية، وبخاصة الإسلامية، من دوائرها الروحية الدعوية إلى الموجِّه الفاعل للفضاء العام وسياسته.
وفيها قفزت المؤسسات الدينية، بتعددها، لتملأ الفراغ، ويجد عندها تابعيها الملاذ والتحقق، ويتعمق الفرز ومن ثم الشرخ، ولا يعود الوطن الكيان الحاضن والموحِّد والقادر على قبول التعدد والتنوع واستثمارهم كقوة تحمي أرضه ونهره وناسه، وتضمن تقدمه وازدهاره.