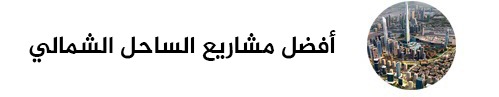«أولادكم ليسوا لكم أولادكم أولاد الحياة»
الأب أغسطينوس بالميلاد ميلاد سامي ميخائيل بطرس
"وإن كان أحد لا يعتني بخاصته، ولا سيما أهل بيته، فقد أنكر الإيمان، وهو شر من غير المؤمن." (1 تي 5: 8).
"وقصها على أولادك، وتكلم بها حين تجلس في بيتك، وحين تمشي في الطريق، وحين تنام وحين تقوم،" (تث 6: 7).
"أيها الآباء، لا تغيظوا أولادكم لئلا يفشلوا." (كو 3: 21).
من هم الأهل؟ ومن هم الأولاد؟
إنه ومن الطبيعي أن نتوقف عند علاقة الأهل بالأبناء. هذه العلاقة مهمة للغاية لأنها أساس كل مجتمع، ومن خلالها تبنى أجيال المستقبل. وكلنا نعرف أن هذه العلاقة شائكة لا تخلو من الصعوبات وأحياناً من المشاكل. يعود هذا الأمر لعدة أسباب أولها وأهمها ما يسمى بصراع الأجيال.
وهذا يرجع للاختلاف الكبير بين الأجيال وهذا شيء طبيعي لا مفر منه. إن هذا الصراع موجود منذ الأزل لكن دون شك مع التطور الذي عاشته وتعيشه البشرية اليوم وخاصة وسائل التواصل بشتى أشكالها تعمق هذا الصراع.
كما نعرف إن التهم متبادلة بين الأجيال، فالأبناء يعتبرون أهلهم (دقة قديمة) وليسوا قادرين على محاورتهم، والبالغون يقولون إن هذا الجيل (فارغ ولا خير منه). حتماً كلا الطرفين ليس لديه حق في مقولته، حتى ولو فيه شيء من الصحة.
عفويا ً يتبادر للذهن سؤال أمام هذا الوصف عن كيفية إلغاء هذا الصراع. هذا السؤال وهمي تماماً فهل يمكننا أن نطلب من المراهق ألا يكون مراهقاً؟
هذا مستحيل لأن هذا الصراع هو أمر طبيعي وليس المهم إلغاؤه لأن ذلك مستحيل وإنما المهم كيفية التعامل معه بالشكل الأفضل.
قبل الدخول في الموضوع لابد من سؤال أولي:
لمَ ننجب الأولاد؟
الأكيد أن الجواب متعدد الأوجه كأن نقول إن أي زوجين عندما يتزوجان من الطبيعي بالنسبة لهما أن ينجبا الأولاد أو أن يكون الأولاد جزءاً من حياتهما الزوجية، أو يشكل الأولاد استمرارية الأهل ويخلدون ذكر الأهل والعائلة، أو كما يقال الأولاد سند الأهل في شيخوختهم....
إذا فكرنا قليلاً بهذه الأجوبة فإن أول ما يلفت انتباهنا هو أنه لا وجود للأولاد لأنفسهم، لأنهم إما أنهم نتيجة الطبيعة أو سند لأهلهم بشيخوختهم.
هذا يستوجب طرح السؤال من هم الأولاد بالنهاية؟
للإجابة على هذا السؤال يجب أن نحدد مفهومنا للحياة وللإنسان بنفس الوقت. فنحن متفقون على أن الحياة أعطية أي أننا نستقبلها من آخر، تعطى لنا الحياة.
فلا يوجد من يدعي أنه مصدر الحياة فهي ليست ملكاً لأحد، والأولاد هم من نتاجها حيث أُعطيت لهم حتى يعطوها بدورهم للآخرين، والأهل هم الوسيلة التي تنتقل الحياة من خلالها من جيل إلى جيل.
هم الوسيلة التي تؤمن استمرارية الحياة وهذا شيء مهم لأننا نعتقد أن الوسيلة لا شيء. الوسيلة دائماً مهمة لأننا عندما ننقل أي شيء وأي مادة بوسيلة معينة فهناك تفاعل بين الناقل والمنقول، بين الوسيلة والمحتوى.
فالإنسان كائن حضاري يتطور وينمو ويتكون ويصبح إنساناً من خلال الحضارة التي هي جملة التطورات والخبرات التي يعيشها الإنسان أثناء مسيرته الحياتية.
وبالتالي كل القيم الأخلاقية والإنسانية التي تلقيناها بكل سهولة من مجتمعنا وأهلنا هي قيم حضارية تتفاعل مع كل ما تعيشه البشرية من تقلبات وتطورات.
إذاً الإنسان في تطور مستمر ومن المستحيل أن نحده بتعريف ثابت ودائم كما سبق ولاحظنا. يعقد هذا في بعض الأحيان العلاقات الإنسانية لكنه في الحقيقة والعمق هو غنى لهذه العلاقات.
إذا قبلنا بهذا المبدأ يمكن أن نجيب عن السؤال من هم الأولاد؟
الأولاد هم أعطية من قبل الحياة، أي من قبل الله. بالطبع ككل أعطية يمكن للإنسان أن يستقبلها وأن يرفضها فالحرية متروكة للإنسان.
يمكن للأهل أن يعطوا الحياة أولا يعطوها، بهذه الحالة يكونون رافضين كلياً لمبدأ الحياة كهبة مجانية معطاة لهم ورافضين أن تعطي الحياة ذاتها فيهم ومن خلالهم.
يختبر الإنسان بعلاقاته وخاصة ً الزوجية والعائلية بأنه يحيا بمقدار ما يعطي حياته للآخر. وأنه من خلال العطاء يستقبل الحياة، لأن الحياة لا توجد إلا من خلال عطائها لذاتها أو استقبالها لذاتها. هذا يعني أنه لا يحق لأحد أن يمتلك أحداً، وهذا هو الحب.
إذا كانت العلاقة الزوجية أو العائلية مبنية فعلاً على الحب فلا يمكن أن تكون علاقة تملكية لأن الحب الحقيقي لا يعرف إلا العطاء.
ستقولون إن هذا الكلام نظري، قد يتضمن ما هو نظري ومثالي لكن فيه الكثير من الواقعية والصحة أيضاً ولو بدرجات خفيفة مختلفة.
كل واحد منا يختبر بطريقة ما مجانية العطاء. أنتم الأهل دائماً تنادون بمجانية عطائكم لأولادكم وهذا كلام فيه بالطبع الكثير من الصحة.
تقول العلوم الإنسانية بشكل عام والتحليل النفسي بشكل خاص إن الطفل هو مشروع وبالتالي لابد للأهل من التحضير له، أن يستعدوا لإنجاب واستقبال هذا الطفل المشروع.
فالطفل ليس نتيجة أوتوماتيكية لعلاقة زوجية بين الأهل فحسب، يمكن أن يكون هكذا لكن لا يمكن أن يعتبر إنساناً.
كلنا نعرف عدد الأطفال الذين يولدون ويقول أهلهم عنهم إنهم غلطة. إذا حللنا هذه الكلمة نفهم أن الطفل الذي يتم التحضير له والتخطيط لمجيئه لا يمكن ان يكون غلطة بل يكون بالفعل مشروعاً والتحضير لا يقتصر فقط على اتفاق الزوجين على إنجابه بل يتطلب رغبة بالعمق بهذا الطفل كي يتم إنجابه له وليس للأهل ولا إرضاءً لحاجة عندهما - لغاية في نفس يعقوب كما يقال - آخذين بعين الاعتبار كل التغيرات التي تسببها ولادة الطفل الجديد.
يسعى كل إنسان للخلود، والأبناء أفضل وسيلة لتحقيق هذا الأمر. نقول باللغة الدارجة (من خلف لم يمت)، بالإضافة إلى أن الإنسان غالباً ما يعيش ذاته على أنه مصدر للحياة.
ولهذا السبب في حالة استحالة الإنجاب تكون الكارثة، فيرفضون حتى مبدأ التبني بالمقابل بمقدار ما يقبل الأهل أن الأبناء ليسوا وسيلة للخلود أو لإثبات قدرتهم على الإنجاب وإعطاء الحياة عندها يكونون قادرين على القبول بمبدأ التبني أو على الأقل ألا يكون عدم الإنجاب كارثة بالنسبة لهم.
ليست رسالة الأهل مع أبنائهم بالأمر السهل بلا شك، وعندما نقول إن الطفل مشروع هذا يعني بأن الأهل يعرفون بأن أولادهم ليسوا ملكاً لهم كما يقول جبران خليل جبران "أولادكم ليسوا لكم أولادكم أبناء الحياة".
تقتضي العلاقة الحقيقية غير الامتلاكية من الأهل أن يربوا أولادهم من أجل أولادهم وليس من أجل الأهل.
هذه أفضل رسالة يمكن أن يقوم بها الأهل وهي نقطة مهمة للغاية وتساعد على التخفيف من العديد من الصعوبات والمشاكل في العلاقة بين الأهل والأبناء.
يمكن أن تقولوا هذا صعب جداً بل قد يكون مستحيلاً لكن الموضوع يتعلق بمفهوم كل إنسان لذاته، الأمر بكل بساطة يتطلب أن نكون واقعيين. فأنتم الأهل أي الزوج والزوجة هل يقبل أحدكما أن يكون ملكاً للطرف الآخر بما فيه زوجته أو زوجها. غالباً ما ننسى هذا الأمر فإذا كنت لا أقبل بذلك فكيف أقبل أن يكون أولادي ملكي.
كل العلاقات الإنسانية هشة وحساسة وغالباً لا تستمر لهذا السبب، لأن كل إنسان يبني علاقته مع الآخر ويسعى لامتلاكه.
في البداية يسايرون ويجاملون ولكن سرعان ما تظهر الحقيقة وتبدأ الاتهامات. لذلك يجب أن نعي أمرين في غاية الأهمية عندما نريد بناء علاقة إنسانية حقيقية.
الأمر الأول: أهمية حرية الفرد واستقلاله.
والأمر الثاني: لا وجود لنمو فردي أو فرح حقيقي إلا مع الآخرين ومن خلالهم.
فأنا أنمو بمقدار ما أترك الآخر ينمو، هذا الأمر يعني الطرفين الأهل والأبناء.
وتتم عملية النمو بطرق عديدة لا شك أن أهمها وأساسها وجوهرها هو:
أ ـ الحب المتبادل.
ب ـ احترام حرية الطفل وإفساح المجال له ليعبر عن نفسه...
ج ـ القبول بخبرات الأولاد.
يُعاش احترام الحرية قبل كل شيء من خلال الإصغاء للأبناء، لما يعيشونه وخاصةً ضمن جو من الثقة بدلاً من القمع أو النهي المستمر أي الإصغاء دون حكم وبالتالي إمكانية التعبير عن الذات فالتعبير عما يعيشه الإنسان إيجابياً كان أم سلبياً هو الأفضل للنمو النفسي والإنساني والعاطفي السليم. والإصغاء للأبناء بحب واحترام وثقة يساعدهم على الحكم على ما يعيشونه وبالتالي التمييز بين الجيد والسيء.
فإذا كانت خبرة الابن مرفوضة مسبقاً فذلك يعني إلغاء كل إمكانية التمييز والحكم وبالتالي إمكانية النمو.
لا خوف من الخبرات التي يقوم بها الأولاد من أي نوع كانت مادام باب الحوار والثقة مفتوحاً أمامهم.
وما من أخطر من إقفال هذا الباب في وجههم إذ يبدأ هذا الأمر منذ الطفولة. حيث ننظر للطفل على أنه عجينة نستطيع أن نصنع منه ما نريد ونسيره حسب قناعاتنا. فليكن، لكن هذا لا يمنع أن نعطيه الثقة ونبني العلاقة معه على أساس الحوار فالطفل - خلافاً لما تعتقدون - مهما كان صغيراً له عالمه وأفكاره على قدر إمكانيته بالتأكيد، لكن لا يحق لنا تجاهلها واعتبارها مسألة أطفال.
اسمحوا لي أن أشير إلى تناقض أنتم تعيشونه، عندما يأتي الأهل مثلاً ويقولون إن عند ابنهم مشكلة صغيرة. يظلون يمدحون بإمكانياته وذكائه وقدراته بالنسبة لعمره وبالمقابل يتعاملون معه على أنه طفل. فإما أن تعامله حسب قدراته أو تعامله على أنه طفل.
ليست أفضل طريقة للتعبير عن حب الأهل لأبنائهم هي العواطف على الرغم من أهميتها ومكانتها وإنما الثقة والحوار هما الأساس وهما أفضل تعبير عن الحب.
لكن حتى يكون الإصغاء جيداً ينبغي أن نخلق جواً محباً من الحرية والثقة وينبغي أن يصغي الأهل لأبنائهم انطلاقاً من أبنائهم وليس انطلاقاً من ذواتهم.
كتوضيح لذلك على سبيل المثال عندما يبدأ الطفل الصغير بكلماته الأولى لا يفهم عليه أحد غير أمه لأنها معه كل اليوم وتصغي إليه فأصبحت تعرف معنى كل كلمة يقولها ولو لم تكن مفهومة لغوياً وحرفياً.
وبالتالي لكل إنسان مفرداته وقاموسه أي بقدر ما أصغي لأولادي أفهم لغتهم، وإصغائي الجيد لهم يجب أن يكون انطلاقاً منهم وليس مني.
يعني إذا كنت أعتبر الموضوع خطاً أحمر أو سخيفاً أو جريمة فقد يكون بالنسبة للأولاد عكس ذلك.
لذا يجب أن أضع نفسي مكانهم وأحاول أن أنظر للموضوع بمنظورهم أو مفهومهم حتى أستطيع استيعابهم ونستطيع الوصول معاً إلى حوار حقيقي.
من الطبيعي أن يكون تفكير الأبناء مختلفاً عن تفكير الكبار وخبراتهم وأنا دائماً أقول للشباب لدى أهلكم خبرات لا تقدر بثمن وأنتم لا تعرفونها لذا من الضروري أن تصغوا لأهلكم وتستفيدوا من خبراتهم بدون أحكام مسبقة عليهم كمقولة (دقة قديمة وجيلهم مختلف، إلخ).
وقبول خبرات الأولاد يعني القبول بالتجربة أي القبول بالضياع.
فأنا كأهل إلى أي حد أقبل بضياع ابني؟
هذا السؤال قوي. منذ زمن كنت أحضر الرياضات الروحية للأهل فطرحت عليهم هذا السؤال الذي لا شك أزعجهم مني.
يعني الضياع أن أقبل أن الطفل قد يخطئ أو سيخطئ حتماً وهذا طبيعي، وهو يريد أن يعيش مغامرته حتى يميز لاحقاً الخطأ من الصواب.
فدورنا في هذه الحالة أن نرافقه بهذه الخبرة من خلال إصغائنا له.
سأعطي لكم مثلاً أنتم رجعتم من سهرة ما فدخلتم المنزل ووجدتم أولادكم يشاهدون فيلماً جنسياً. ستكون ردة الفعل التقريع وإغلاق الجهاز، لكن هنا تكونون قد قطعتم العلاقة معهم. بينما لو شاهدتم قليلاً منه معهم لثلاث أو أربع دقائق وتوقفتم بعدها عندها تخلقون فرصة من ذهب كي تعطوهم المعنى الإنساني للجنس وتوعوهم بأن هذه الأفلام ما هي إلا تشويه كامل وكلي ليس للجنس فحسب وإنما للإنسان بشكل عام وللعلاقات الإنسانية. فعندكم باب لا يقدر بثمن.
عندنا في الإنجيل مثل مهم عن الضياع وهو مثل الابن الضال الذي أعطاه أبوه حصته في الوقت الذي ليس له الحق بها ما دام الأب لا يزال على قيد الحياة ولم يقل له كلمة واحدة.
وعندما قبل الأب أن يضيع ابنه وقبل أن يصل إلى هاوية الموت اكتشف الابن أن الحب الحقيقي والفيض موجودان عند أبيه فيرجع إلى أبيه ويعترف بخطئه.
بينما الابن الأكبر الذي لم يترك أباه وبقي في حضنه لم يكتشف خطأه واستمر به.
فالإنسان الحقيقي هو الذي يختبر الحياة وتختبره، طالما لم يختبر الإنسان الحياة ولم يعاركها لن يكون إنساناً.
في اللغة الفرنسية يقولون هذا شخص قادم من بعيد أي أنه "ذو باع" حيث تستطيع أن تتكل عليه لأنه يعرف الحياة ويستطيع تمييز الأمور عن بعضها.
لكن للأسف الشديد في هذه الأيام إن همّ الأهل الأكبر هو أن يبعدوا عن أبنائهم الهموم والشعور بالمسؤولية فتظل الأم تقوم بدور الأم الدجاجة الحاضنة حتى يبقى الابن اتكالياً رافضاً الاستقلالية ويصبح ما يسمى بالطفل الملك، أو ابن أمه.
هل هذا يعني ألا يقول الأهل شيئاً لأبنائهم ويدعوهم لمزاجيتهم ولخبراتهم؟
بالطبع لم يكن هذا ما أردت قوله.
فعلى الأهل أن يفيدوا أولادهم من خبراتهم وعلى الأولاد أن يحترموا ويستفيدوا من خبرات أهلهم لكن بحرية.
هذا دور الحوار بين الطرفين والحرية لا تعني إطلاقاً المزاجية، وعدم المزاجية لا يعني القمع. هذا هو التوازن الذي ينبغي على الأهل أن يحققوه.
تبقى الحياة أعطية وبقدر ما أعيشها على أنها أعطية بقدر ما أستطيع بناء علاقة غير تملكية مع الآخر وبشكل خاص مع أولادي.
لأنني عندما أستقبل الحياة كذلك فأنا أكون حراً لا أخاف على شيء. فبمقدار ما أعيش على أنني أنا المصدر بمقدار ما يكون موقفي دفاعياً وقلقاً ولا يسمح لي قبول اختلاف الآخرين عني وبشكل خاص أولادي فأنا أسعى آنذاك لكي أحقق من خلال أولادي الشيء الذي لم أستطع تحقيقه في حياتي.
فمثلاً:
كنت أريد ان أصبح طبيباً ولم أستطع فسأظل ألح على أحد أولادي كي يصبح طبيباً، إن هذه علاقة مشوهة امتلاكية ومليئة بالصراعات بيني وبين أولادي.
هل يعني أنه بهذه الطريقة يمكن إلغاء الصراعات بشكل عام وصراع الأجيال بشكل خاص؟
حتماً لا يمكن على الإطلاق إلغاء الصراعات وليس المطلوب إلغاءها لأن الصراعات تشكل ديناميكية الحياة وفي كل المجالات.
فالمطلوب الاعتراف بهذه الصراعات وقبولها والتعامل معها من خلال الحوار المستمر من أجل سعي أفضل نحو الحقيقة التي لا يمتلكها أحد ولا توجد في مكان ما. الحقيقة نصنعها من خلال سعينا وبحثنا عنها من خلال هذا الحوار الذي تحدثنا عنه.
وعلينا أن نفهم
إذا كانت الحياة أعطية فأولادنا هم كذلك أي أولادنا ليسوا ملكاً لنا والعلاقة معهم يجب أن تبنى على الحب والثقة والحوار.
هذا يعني قبول اختلافهم والسماح لهم بأن يقوموا بخبراتهم وتجاربهم وإن ما نسميه صراع الأجيال أمر طبيعي لا بل صحي.
فالثقة والحوار يعنيان القبول بأن لهم عالمهم، وتفكيرهم، وخبراتهم. وأخيراً للوصول إلى تحقيق كل ذلك على الأهل أن يعبروا من أصحاب سلطة تأمر وتنهي إلى مرافقين يساعدون أبناءهم على التمييز، وهذه أهم وسيلة لعيش حياة حقيقية.
الأسس العامة لتربية الأطفال في الوقت المعاصر:
كيفية تربية الأطفال
أولاً - بالنمو بالانطلاق وليس بالكبت.
ثانيًا ـ بالبناء بالقدوة والتسليم.
ثالثًا ـ بالطاعة بالتفاهم لا بالقهر.
رابعًا ـ بالنمو بالمعرفة لا بالتكتم.
خامسًا ـ بدراسة ومعرفة روح العصر ومواجهة سلبياته.
سادسًا ـ الفردية بصورتها الحادة.
أولاً - النمو بالانطلاق وليس بالكبت:
كانت النظرية القديمة في التعليم أن يلقي المعلم معلوماته إلى التلاميذ، فالمعلم الناجح هو من يسكب المعلومات على الطلاب لكي يستوعبوا المادة الدراسية.
أما وقد تغيرت هذه النظرية فقد ثبت أن التعليم ليس بسكب المعلومات على العقل، وانما التعليم الصحيح هو بالنشاط الذاتي من المتعلم، وهذا ما يسمى التعليم بالخبرة.
لهذا أصبحت عملية التربية تسهل الاكتساب للخبرات والعادات والمهارات والمفاهيم السليمة.
ومن هنا بدأت مهمة المربي كموجه وكمكتشف لمواهب التلاميذ واستعداداتهم وقدراتهم.
أن التعليم السليم الآن هو بالانطلاق، أي باستغلال القدرات الانسانية، وبتوجيه هذه القدرات للنمو الأفضل.
أما الكبت والضغط والارهاب فهذه كلها قد أصبحت مخلفات عمليات قديمة لا تصلح للتربية في عصرنا هذا.
والأسئلة الموجهة إلى الآباء المربين والقادة في الكنيسة هي:
1 ـ هل نحن نحترم تفكير الطفل ومواهبه واستعداده وقدراته مهما كانت مبتدئة وبسيطة؟
2 ـ هل نشجعه على التفكير والتأمل والحوار البناء؟
3 ـ هل نحن نشجع الأطفال على النمو من خلال النشاط والخبرة والممارسات العملية؟
وإذا كانت بلادنا تئن من تركة التعليم القديم الثقيلة، وتلح في المطالبة بتغيير نظم التعليم فما أحوجنا نحن أن نعود إلى مسيحيتنا الأصيلة حينما كان الأطفال يمارسون حياتهم الروحية من خلال النشاط الذاتي تحت توجيه الكاهن ومرتل الكنيسة.
علينا أذن أن نكثر من الأنشطة الروحية والممارسات العملية ونهيئ لكل واحد وواحدة من الصغار مجالًا لإشباع المواهب والقدرات واستخدامها لمجد الله وخدمة الكنيسة.
ان اقامة القداسات، والتعليم والتكوين المسيحي، والمؤتمرات، والندوات، والمهرجانات، والرحلات الترفيهية والثقافية... والخاصة بكل مرحلة من مراحل النمو، وتقسيم الأولاد إلى أسر تحت اشراف رواد فاهمين لمسئولياتهم التربوية للمنافسة حول الأنشطة المختلفة، هذه وأمثالها طرق تربوية سليمة يجب ألا يفوتنا تنظيمها ليتحقق لأولادنا النمو السوي من خلالها.
ثانياً - البناء بالقدوة والتسليم:
كثيرًا ما يلجأ المجتمع إلى الشعارات والعظات والندوات والمحاضرات ووسائل التوعية وهذه كلها مطلوبة ولكنها لا تستطيع أن تؤثر في أعماق الانسان.
أما المنهج المسيحي الأصيل، والكنسي المدروس، فهو الانجيل المعاش أي الحياة المسيحية الاختبارية. وهذا المنهج يتفق مع مبادئ علم النفس الحديث، وعدم الاجتماع، لأنه معروف أن الطفل لا يتعلم بالتلقين والتحفيظ وحشو الفكر بالمعلومات وانما بالمحاكاة والتقليد والتوحد في المبادئ والاتجاهات والانماط السلوكية من خلال النموذج والقدوة والمثال.
فان وجد آباء ومعلمون ورعاة قديسون مخلصون امناء استطاعوا أن يبنوا النفوس دون أن يعظوا كثيرا. يقول الكتاب المقدس عن الآباء الرسل «لا صوت ولا كلام، في كل الأرض خرج منطقهم وإلى أقاصي المسكونة بلغت أقوالهم» ...
هكذا عاشت الكنيسة طيلة عصورها تسلم طريقة الرب في هدوء ووداعة من خلال أشخاص مختبرين تتلمذوا هم أولًا وذاقوا ومارسوا الحياة النيرة وصارت لديهم القدرة ان يسلموها للآخرين من بعدهم جيلًا بعد جيل وسيظل هذا التسليم قائمًا إلى نهاية الأجيال.
والأسئلة الموجهة هي:
1- هل نحن ندرك جيدًا أن مسيحيتنا حياة عملية تختبر الحياة مع المسيح، وإنجيل معاش ولیست دروس ومواعظ ومعلومات؟
2- هل نهيئ لأولادنا المواقف التربوية لممارسة الأخلاقيات والقيم والمبادئ والأدبيات المسيحية تحت توجيه المربين الواعين؟
ثالثاً - الطاعة بالتفاهم لا بالقهر:
كانت الأجيال القديمة تفتخر بان الصغير تكتم أنفاسه عندما يقابل الكبير أو يراه من بعيد. وكانت تعتز أيضا بأن الصغير لا رأي له طالما كان الكبير حاضرًا.
هذه انفعالات وأفعال ومواقف مضت، وولت شئنا أو لم نشأ.
الطاعة الآن لا تكتسب الا بالتفاهم والحوار الهادئ والاقناع الرصين.
وقد ينجح الكبار في قهر الصغار ولكنهم لن ينجحوا في أن يزرعوا فيهم القيم والاتجاهات المرجوة.
فلكل ضغط شديد رد فعل أشد. والانسان خلق حرًا يكره الاستبداد.
الرب يسوع كان يحترم حرية الانسان
فمثلًا:
عندما كان يعمل المعجزة كان يسأل المفلوج المنطرح، لمدة ثمانية وثلاثين عاما، ان كان يرغب في الشفاء.
والأسئلة المطروحة هي:
1- هل نتفاهم مع أولادنا في القضايا التي تشغل بالهم؟
2 - هل نعطيهم خبرتنا بالحب والاقناع أم بالأمر والارهاب؟
3- هل نأخذ وتعطي معهم حتى تصبح شخصياتهم مستقلة والقرار من صنعهم؟ بمعنى آخر هل نسمح لهم بالحوار البناء؟
4 - هل نملى عليهم شخصياتنا ونريدهم أن يكونوا مثلنا أم نعدهم لمستقبل مختلف عن حاضرهم؟
5 - هل هم وسيلة لإشباع حاجات الكبار وحرمانهم من حاجياتهم؟
6 - هل نجعلهم وسيلة لنمو العصبية الأسرية والقبلية؟
رابعاً - النمو بالمعرفة لا بالتكتم:
كان القدماء يفتخرون أن أولادهم لا يعرفون شيئا عن الحياة. إنهم يعتمدون عليهم اعتمادًا تامًا. ما كان واحد يجرؤ أن يسأل والديه سؤالًا خاصًا بالناحية الجنسية.
لم يكن ناشيء يفكر أن يغادر بلاده إلى منطقة بعيدة ولو لزيارة سريعة.
أما الآن فالفتيان يسافرون إلى أوروبا وحدهم ويقرأون ويشاهدون ويسمعون البرامج والمعلومات عن كل جانب من جوانب الحياة، لهذا لا تستطيع الكنيسة أن تتجاهل ما يحدث لهم بل عليها أن تقدم المعلومات الطاهرة السليمة عن الإنسان والمجتمع وترد على الأسئلة والقضايا التي تواجه الناشئة والشباب بأسلوب روحي وعلمي يتناسب مع كل مرحلة نمو.
والأسئلة المطروحة هي:
1 ـ هل أعددنا الكُتيبات والنُبُذات بكافة المستويات لشرح القضايا الحيوية؟
2 ـ هل أعددنا الخدام والآباء للتوجيه والريادة ومعالجة مشكلات الحياة المعاصرة؟
3 ـ هل نعالج أسئلة الصغار بالموضوعية أم بالانفعال والغضب الأعمى؟
4 ـ هل نهتم في معالجة القضايا بالجوهر أم بالشكل والمظهر؟
5 ـ هل نؤكد على اللقاء المستنير بين العلم والدين أم نرفض كل من المعطيات العلمية ووسائل التكنولوجيا الحديثة...؟
6 ـ هل هيأنا للأطفال لمعرفة الحضارات والمعلومات المعرفية فالرحلات والمعسكرات للأماكن الأثرية والتاريخية والجغرافية والدينية؟
7- هل نعمل على تنمية المفاهيم الحياتية للمسيحية، والعمل الجماعي، وكيفية تحقيها من خلال معايشتنا للوقع مع الناس رغم الصعوبات التي سيوجهونها؟
8 ـ هل زرعنا الانتماء الوطني بالروح الوطنية وأصلحنا المفاهيم في أبنائنا على ضوء المبادئ المسيحية ومن أجل تحقيق انتمائهم إلى بلدهم بعيدا عما درسوه من معلومات تاريخية مغلوطة وغير حقيقية وأحيانا مزيفة؟
9 ـ هل ربيناهم على الانفتاح وقبول الآخر وعدم التعصب الطائفي والمذهبي والديني؟
10 ـ هل زرعنا فيهم روح المبادرة والمجازفة ولكن بوعي ودراسة وشجاعة؟ أم زرعنا فيهم الخوف وعدم الثقة بالنفس وروح الفشل؟
خامساً ـ دراسة روح العصر ومواجهة سلبياته:
إن الكنيسة اليقظة تعيش في العالم نورًا يضيء وملحًا يُصلح ويعطي مذاقًا.
انها ليست في فراغ أو في أبراج عاجيه لكنها تعرف معاناة الإنسان وآلامه ومشكلاته.
لهذا تدرس ظروف الحياة وسمات العصر وبالأخص سلبياته حتى تحصن أولادها ضد الأمراض الاجتماعية لئلا تتسلل جراثيمها إلى أرواحهم ونفوسهم فتفسد الجهود المضنية التي تبذلها لإعداد الشبيبة للحياة المقدسة.
ويمكننا أن نلخص أهم السلبيات التي جاءت في دراسة علماء الاجتماع لكي نعمل جاهدين على تخليص أولادنا من الانزلاق وراءها.
1 ـ السطحية في الحياة:
السطحية في الأهداف: في الدراسة والتحصيل العلمي، في التفكير والحوار، في انتقاء شريك الحياة واتخاذ قرارات مصيرية في مواقف الحياة. هذه الظاهرة الخطيرة لها أسبابها العالمية والمصيرية وعلينا أن نواجهها بالجدية والعمق في كل جوانب الحياة...
تعويد الإنسان أن يتعب في حياته الروحية ليكون عميقًا في صلواته ودراساته واعترافاته وتلمذته وأصوامه وجهاده.
تعويده الجدية والعمق في دراسته وتحصيله العلمي لكي يتفوق لا أن ينجح عن طريق الملخصات والمساعدات المشروعة وغير المشروعة والاكتفاء بأقل مستوى من المناهج للحصول على الرخصة العلمية التي تؤهله للوظيفة التي قد لا يفهم عنها شيئًا ولا يثمر من خلالها ثمرًا ونضجًا وتطويرًا.
الجدية والعمق هي الاحتياج الأول لبناء الفتيان في عصرنا هذا. وقد يتساءل الشباب ما الفائدة من التعب والجهد بينما التقدير الحقيقي هو للفهلوي والسطحي والفضولي والانتهازي؟
والاجابة أن الذي يريد أن يرضي الله لا بد أن يكون أصيلًا لأن الله حق هو ومن أراد أن يخدم وطنه يلزمه أن يكون شمعة مضيئة. قال باسكال: "إني أحافظ على شمعتي لأنها أن انطفأت شمعتي فما الذي يذب الثلوج؟
2 ـ اللامبالاة والتواكل:
تنتشر في بلادنا الآن كلمات غريبة عن أصالة شعبنا مثل (سيبك، معلش، وانا مالي، مفيش فايده...)
والعجيب أن شعبنا هذا هو الذي بنى الأهرامات وأقام حضارة الفراعنة التي أذهلت العالم وقدمت الشهداء والرهبان ومعلمي المسكونة وقادة المدرسة الإسكندرية فكيف بنا نجد البعض الآن متراخيًا في الدراسة المتعمقة غير عابئ بالتحصيل أو التمكن من اللغات الأجنبية، غير مهتم كثيرًا أو قليلًا بالمصلحة العامة بينها تهمه المصلحة الشخصية وبالأخص الحوافز المادية؟
كلنا نعلم ونرى في الكثير من البلاد الأوربية الناس مهتمين كثيرًا بترقية أحوالهم الاجتماعية والثقافية والمعمارية، مشغولين ببذل كل جهدهم لتحصين مرافق الحياة، دون تهاون مع أي إنسان يخرب أي مؤسسة عامة أو خاصة. يخدم الواحد في مصلحة أو شركة كأنه يملكها وكأن العائد كله يعود إلى جيبه.
3 ـ الغش وعدم تحمل مسؤولية تربية النشء
تنتشر بين كثير من الأسر في تعاملاتهم مع أولادهم روح اللامبالاة، أو الفهلوة، والروتين، والزوغان، أو تأدية الصلاة أثناء ساعات العمل، أو الغش وترسب الامتحانات...
فيلزم تربية الناشئة على الفضائل الإلهية الإيمان الرجاء المحبة. والفضائل الإنسانية كالإخلاص والشجاعة والأمان والصدق والغيرة والتفاني بل والتناهي في كل عمل صالح، والانتماءات للأسرة والوطن والإيمان لأن هذه هي سمات الإنسان الأصيل مهما كان الناس وأيًا كانت آراؤهم وأخلاقياتهم لأنه مكتوبه ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس.
4 ـ التزلف والنفاق والرياء والجبن:
هذه الرذائل ان دلت فعلى الضعف النفسي، فالإنسان الحر جريء، والإنسان القوى شجاع، والإنسان الصريح الواضح لا يعرف النفاق أو المديح أو التزلف أو التذلل للآخرين.
مسيحنا ينادي ويقول ان حرركم الابن فبالحقيقة تكونون احرارا. وحكومتنا تنادي بالحرية والديمقراطية والمواجهة والحوار والنقد البناء... وحتى ولو كان هذا كله غير موجود على أرض الواقع علينا ألا نيأس ونستمر في الوعي والتربية والتعليم... فهذه مسئولية التربية في المنزل والمدرسة والكنيسة ومؤسسات المجتمع المختلفة.
4 - التدين المريض:
أسوأ ما أصاب بلادنا في هذه الأيام الموجات الدينية التعصبية ونظرات الاحتقار والتكفير...
هذه ليست دينًا ولكن تشنجًا وهوسًا وانحرافًا يرفض العلم، ويشجب المنطق، يلغى الرأي الآخر، ويدوس على المحبة والألفة والمودة، ويهزأ بالإنسانية وقيمها.
إنها رذيلة تزيد التعصب والانغلاق والعنف والشغب والانسياق وراء الاشاعات والخضوع لقلة تسيطر على الشبيبة إلى حد الغاء شخصياتهم تمامًا.
وواجب الكنيسة أن تحمي أولادها لئلا يشربوا من هذه المياه الفاسدة فعليها أن تنمي الحب وتنادي بالسلام والود وتكرم انسانية الإنسان وتشجب التعصب والتحيز في أي صورة من صوره، وتقدر موضوعية النظرة إلى الحياة، وحق الفرد في تقدير حريته، وتكريم حريات الآخرين، وتكوين قيادات وكوادر تحمل أعلى الشهادات العلمية وأعمق الاختبارات الروحية وأرق المشاعر الإنسانية وأنبل المقاصد الوطنية.
الوطن والكنيسة يحتاجان إلى اعادة النظرة في بناء الإنسان من الداخل والخارج في الجوهر وفي المنظر.
سادساً - الفردية بصورتها الحادة وتقلص العمل الجماعي:
يفرق بردییف المفكر المسيحي بين الفردية والشخصية، الفردية هي التي تدور حول أنانيتها أما الشخصية فهي التي تتجاوز الأنا إلى الآخر، التي تبذل وتقبل الآخرين. الشخصية خصيبة والفردية عقيمة.
وفي مجتمعنا تنجح الحوافز الفردية بينما تتضاءل البواعث الجماعية. وينجح العمل عندما يوكل إلى واحد ولكنه يفشل نهائيا إذاً أحيل إلى لجنة، يبرز القائد لأن من حوله فريقًا يعمل معه ولا يعمل به..
يمركز المسئول كل السلطات في يده ولا يثق في أحد سوى نفسه فقط، ولا يتعب في توزيعها؛ بينما القائد الناجح هو الذي يولد المزيد من القيادات، وينمي المواهب، ويصقل الشخصيات ويخصب الكفاءات ويشجع الموهوبين.
في بلادنا ينهار العمل عندما يختفي المسئول بينما في البلاد الأكثر وعيا وتقدما نجد الجماعة أقوى من الشخص والقاعدة أقوى من القمة...
في سفر الأعمال نجد أن الرسل كانوا يعملون في الهيكل بروح واحد ولهم القلب الواحد والفكر الواحد...
الروح القدس يعطى النعمة للغلبة على الأنا، ومهمة التربية أن تنمي في المؤمنين روح الفريق، روح الجماعة، حياة الشركة وتجاوز الفردية والتسلطية.
والأسئلة الموجهة هي:
1- هل ننمي في أطفالنا روح الفريق والجماعة في العمل أم روح العزلة والانفرادية؟
2 - هل نربي أولادنا على محبة القريب كالنفس أم نجعله يتمركز حول ذاته غير معترف بالآخر في حياته؟
3- هل لدى أولادنا مقدرة على الانفتاح على الآخرين وقبولهم داخليًا مهما اختلفوا معهم فكرًا أو مزاجًا؟
4 - هل في تعاملهم مع الآخرين يتجاوزون المستويات الخلقية المتعارفة والقوانين الوضعية إلى مستوى البذل والالهام والحق والابداع؟
الأب أغسطينوس بالميلاد ميلاد سامي ميخائيل بطرس...
F Oghos Melad